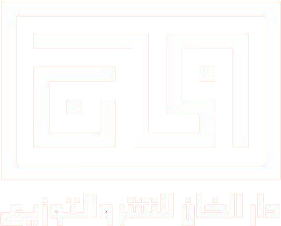غراهام فيليب –
ترجمة: مهدي سليمان:
إن الترجمة الإنكليزية لسلسلة روايات “الحي” هي أول الغيث العميم لأحد أهم أعمال الكاتب البرتغالي غونزالو تافاريس وتقديمه لجمهور القراء في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر تافاريس أحد أعظم الكتاب البرتغاليين الأحياء. وبالرغم من بلوغه الأربعين منذ مدة وجيزة، فقد بنى لنفسه مكانة في تاريخ الأدب البرتغالي. ورغم أنه لا يزال غير معروفٍ نسبيًا في أمريكا الشمالية (حيث نشرت دار دولكي أركايف روايته القدس عام 2009)، إلَّا أنَّ أعماله حصدت عددًا كبيرًا من الجوائز، ناهيك عن ترجمتها وحصولها على الثناء والتقدير في أكثر من خمسة وأربعين بلدًا من بينها إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا والهند وبولندا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليونان وألمانيا والأرجنتين. وتحوَّلت أعماله في بلده البرتغال إلى مسرحيات وترانيم دينية وعروض أوبرالية.
كان أول عهدي بالتعرف على أعمال تافاريس أثناء حضوري المؤتمر الدولي التاسع للقصة القصيرة الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة في شهر يونيو من سنة 2006. كان الجميع يلهج باسم تافاريس في المؤتمر، فقد فاز بجائزة خوسيه ساراماغو الأدبية في العام الفائت وذلك عن روايته الثالثة “القدس” – كما أن ساراماغو نفسه، وهو الحاصل على جائزة نوبل للآداب، لم يتورَّع أبدًا عن كيل المديح والثناء لتافاريس حين قال: “إن رواية “القدس” رواية عظيمة، وتستحق بجدارة أن تنال مكانتها ضمن الأعمال العظيمة في الأدب الغربي. قد لا يستطيع أي شخص كان أن يكتب بمثل تلك الجودة والبراعة التي يكتب بها تافاريس وهو في سن الخامسة والثلاثين. لذا أشعر برغبتي في لكمه في وجهه غيرةً وغبطة!”
وعندما حضرتُ الأمسية التي قدَّم فيها تافاريس قراءات من قصصه في مؤتمر لشبونة الأدبي، استمتعت للمرة الأولى لمختارات من السلسلة الروائية المعروفة بالبرتغالية بعنوان (Os Senhores) والتي ترجمت إلى الإنكليزية بعنوان (The Misters) أي “السادة”؛ وهي مجموعة الروايات القصيرة التي تشكل بمجموعها سلسلة كتاب “الحي”. وقد أدهشني على الفور الإيجاز والجزالة اللذان يميِّزان أسلوبه الكتابي. وقبل توجهي للبرتغال لحضور فعاليات المؤتمر المذكور، طلبتْ مني هيئة تحرير المجلة الأدبية المعروفة باسم هنْغَر ماونتن أن أساهم في إعداد ملف خاص عن الأدب الروائي البرتغالي المعاصر يضم بين دفتيه الكتَّاب الذين صادفتُهم في المؤتمر. ولهذا لجأت إلى أسهل قرار يمكن للمرء أن يتخذه بأن ضمَّنتُ ذلك الملف خمس قصص قصيرة من كتاب السيد هنري وست قصص أخرى من كتاب السيد بريشت وهما من ضمن سلسلة “الحي” التي ألَّفها تافاريس. وباعتباري المحرر الأدبي لمجلة ناينث لِتَر التي تعني بشؤون الأدب والفن، فقد قمت أيضًا باختيار خمسة أعمال مختارة للنشر من رواية السيد فاليري. وهذه النصوص المحدودة تمثل الانطلاقة الأولى لظهور أعمال تافاريس باللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن، وفي ظل هذه الترجمة الضخمة التي بين أيدينا، والصادرة عن مطبعة جامعة تكساس التقنية، فستتاح لجمهور القرَّاء في أمريكا الفرصة للاستمتاع ببراعة العالَم الخيالي الفريد الذي يصوغه تافاريس من خلال ولادة هذا النص الأنيق الذي خطَّت ترجمته الإنكليزية البديعة أنامل المترجمة روبانجالي روي.
وقد يكون خليقًا بنا أن نعرِّف القارئ الذي لم يسبق له الاطلاع على أعمال تافاريس الكاملة من خلال مناقشة الرسومات التي أبدعتها زوجة تافاريس وشريكته في الأعمال الأدبية لمدة طويلة، الفنانة راتشيل كايانو، وخصوصًا اللوحة التي رسمتها التي تمثِّل خريطة الحي، حيث يظهر فيها الشوارع الضيقة والمباني المتلاصقة التي تمثِّل حيًا تقليديًا في مدينة لشبونة. وقد رسمتْ كايانو في خريطتها التي أبدعتها في الطبعات الأولى من سلسلة “الحي” أربع شخصيات فقط من سكان الحي وهم السيد فاليري والسيد هنري والسيد بريشت والسيد خواروز، مع العديد من الشقق المحيطة بهم وهي فارغة من ساكنيها. ومع اتساع رقعة مشروع تافاريس الروائي، أضاف إلى الحي كل من السيد كالفينو والسيد كراوس ومن ثم السيد فالْسِر. وحتى تاريخ كتابة هذه السطور ينتشر، لحسن الحظ، على الخريطة التي رسمتها كايانو تسعة وثلاثون اسمًا. وبالرغم من أن عشرة من هؤلاء السادة فقط قد ظهروا حتى الآن بشكل كتب مستقلة (وبعضها ما يزال بانتظار ترجمته للإنكليزية)، فهي تمثِّل بمكنوناتها النمو المتواصل لسلسلة “الحي” في المستقبل.
أما بالنسبة لرسومات كايانو الموجودة في داخل كتب السلسلة، فتعكس أساليبها الفنية المتبدلة ما يضمه كل كتاب من كتب السلسلة من ذلك الجمع الفريد بين الغرائبية الطريفة والجدية. ويبدو العديد من تلك الرسومات بحق مرتبطًا ارتباطًا عضويًا معقدًا بكل قصة على حدة، ومن أمثلة ذلك الحزن الرهيف لدُرْج خزانة السيد خواروز المملوء بالفراغ؛ أو الخطوط الإضافية للقبعة المستديرة التي يعتمرها السيد فاليري؛ أو الظلال العريضة المحيِّرة لمكتب الزعيم في قصة السيد كراوس؛ أو الخربشات الجنونية التي تخطط التفكيك الودي للمنزل الريفي للسيد فالْسِر.
ولا بدَّ أن قارئ هذه المقدمة قد لاحظ بالتأكيد أن كافة السادة يستدعون في الذاكرة شخصيات أدبية بارزة. إذ تمارس تلك الشخصيات أدوارها الروائية، إلى حد ما، في نطاق ما نعتقد أننا نعرفه من معلومات عن تلك القامات الأدبية، والأهم من ذلك ما نعرفه عن كتاباتهم. فالسيد كالفينو بالطبع هو النسخة الأدبية عن كاتب الحكايات الإيطالي إتالو كالفينو؛ أما السيد فاليري ففيه تلميح للشاعر والناقد الفرنسي بول فاليري؛ أما السيد خواروز فهو نسخة ما من الشاعر الأرجنتيني روبرتو خواروز؛ والسيد فالْسِر عاشق العزلة (إذْ قد يلاحظ المرء بأن بيته يقع على مسافة بعيدة من المباني السكنية الأخرى الموجودة على خريطة الحي التي رسمتها كايانو) يمثل روبرت فالْسِر، الكاتب السويسري المأزوم نفسيًا الذي أدمن السير وحيدًا لمسافات طويلة؛ وتعكس قصص السيد كراوس النقمة السياسية واللغوية للكاتب النمساوي كارل كراوس، أما النفس المخمورة للسيد هنري فهي شذرة منبثقة من شخصية الكاتب هنري ميشو الذي ينتمي للسورياليين الجدد والذي عكف على تجريب شتى أنواع المخدرات أملًا منه في اكتشاف العوالم الداخلية للإنسان. ورغم ما سقناه من إرهاصات لتشابه شخصيات الحي مع شخصيات أدبية حقيقية، فإن كتب سلسلة “الحي” لا تقتصر على إرسال رسالة مباشرة عن تلك الإرهاصات، ولكنها بدلًا من ذلك تفضي بنا إلى مآلات واحتمالات مختلفة – منها الشخصي ومنها الفلسفي – الناتجة عن المعرفة الأساسية بهؤلاء الكتَّاب الذين شكَّلوا مصدر إلهام لتافاريس. وستسيطر مشاعر الحبور والسرور بلا شك على القرَّاء الذين يعرفون عز المعرفة أعمال الشاعر الأرجنتيني روبرتو خواروز من خلال الإشارة الخفية التي يلمِّح بها تافاريس لما يسمى “بالشعر العمودي” الذي يميِّز ذلك الشاعر عندما يقول السيد خواروز في حكاية “الحي” (حيث يخاف السيد خواروز من صعود السلالم النقَّالة): “إذا ما أخذنا في الحسبان بأن السقوط ليس سوى تغيير بسيط في الموقع؛ أو تغيير في وضعية الجسم على طول مسار السقوط العمودي، فحينها لن يكون السقوط مرعبًا جدًا“. بيدَ أن هذه المعرفة الداخلية ليست ضرورية للاستمتاع بالفصل الذي عنوانه “السقوط” في رواية السيد خواروز. والشيء بالشيء يذكر، إذ لا نحتاج لأن يعرف بأن كارل كراوس كان يعتقد بأن سوء استخدام اللغة يعادل سوء استخدام السلطة لكي نستمتع بتلاعب الزعيم بالكلمات في رواية السيد كراوس، حيث يتبادل الزعيم الشديد الحرص الحوار التالي مع أحد مساعديه:
– لا يكفي الحصول على آراء الشعب؛ بل من الضروري تفسير تلك الآراء. فحتى عندما يرسمون مجرد إشارة (+)، يجب أن نعرف ماذا يقصدون؟ ينبغي لكل رأي شخصي أن يفسَّر باستخدام عدسة مكبرة، وأنَّى لأحدٍ أن يقوم بذلك غير أولي العلم وأهل الاختصاص.
– أولئك الذين…؟
– أولئك الذين أسميهم المتخصصين في ذاتي البشرية.
وهكذا لا نتفاجئ بأن الزعيم يعلن على الفور بأن أفضل هؤلاء المختصين في النفس البشرية هو الشخص نفسه، إذ نجده يقول: “بالضبط. أنا! أنا! أنا من يفسر تفسيرًا موضوعيًا الرأي الذاتي للشعب”.
وفي حين أن سخرية معيَّنة، بارعة المواربة، مشوبة بالمرارة كهذا المثال الذي ذكرناه آنفًا، تخلق جوًا يميز كتب سلسلة “الحي”، فهي سخرية دائمًا ما تقترن مع حكمة فلسفية وجدية عميقة في مدلولاتها. ويمكن قراءة قصص روايات سلسلة “الحي” بحد ذاتها قراءة سريعة، ولكنها تظل بحاجة إلى اهتمام وقراءة ثانية بنسق أقل بطئًا. وفي العديد من المواضع، ترشد تلك الروايات القارئ إلى سبل قراءتها. فالحس الفكاهي يحثنا على الغور في القراءة، ولكننا ما نلبث أن نفهم رويدًا رويدًا بأن ذلك الحس الفكاهي يشبه ألغازًا لا حلول لها تسيطر على العالم؛ حس فكاهي تُقدَّم فيه الحماقات الشخصية والمنطقية والسياسية بطريقة تبدو فيها وكأنها تفكك ذاتها، مع الاحتفاظ بشكل مذهل ببنيانها قائمًا متينًا. إذ نرى بأن السيد خواروز، الذي يرى أن التفكير أرفع شأنًا من الانخراط الحسي في العالم، يمتلك دُرْج خزانة أثير على قلبه وقد ملأه بالفراغ، بسبب الإحباط المسيطر على زوجته الصبورة. أما السيد فاليري فهو قصير القامة، ولكن ونظرًا لأنه يقفز كثيرًا، كان بإمكانه أن يزعم قائلًا “أنا ككل الرجال الطوال القامة، باستثناء أنني طويل لمدة زمنية أقصر منهم.”
وتتجلى عبقرية كتاب تافارايس في أنه يُسْبِغُ على أفكاره العميقة أسلوبًا سهلًا جزلًا بطريقة مواربة، مما يمكِّنه من نيل رضا وإعجاب جمهور غفير من القرَّاء. وللدلالة على ذلك دعوني أروي لكم القصة التالية كحجة على ما أقول. فقد أُغْرِمت ابنتي حنَّا، التي كانت في الحادية عشرة من عمرها عندما أقمتُ وعائلتي لمدة سنة واحدة في البرتغال، بكتابات تافاريس. وكان تافاريس في غاية اللطف عندما وافق على قراءة مجموعة من كتاباته في المدرسة البرتغالية حيث كانت تدرس، وعندما وصل إلى المدرسة قدَّم له طلاب الصف السادس عرضًا كمفاجأة له، حيث قاموا بتقديم أداء تمثيلي مفعم بالحماس والحيوية للعديد من القصص الواردة في سلسلة “الحي”. وقد ذهلتُ ذهولًا عظيمًا بالتأثير الذي تركته كتاباته على الصغار قبل الكبار، رغم عدم معرفتهم علم اليقين بالشخوص الحقيقية التي يرمز إليها كل من السيد خواروز أو فاليري أو غيرهم من شخصيات المجموعة.
وكما يرى معظم النقاد، يعدُّ التخيل المدهش لتافاريس من خلال التقمص البلاغي لشخصيات عمله لبعضٍ من أعظم الكتَّاب ممن ينتمون إلى عصر الحداثة وما بعدها مشروعًا متأصلًا أصالة ثابتة الجذور. ومع ذلك يمكن القول بأن السيدين “الحقيقيين” فاليري وهنري كانا الملهمين الأساسيين لسلسلة روايات “الحي” التي ما فتئ مبدعها يرفدها بشخصيات جديدة؛ دون أن ننسى أيضًا أنهما ملهمين أيضًا، بشكل ينطوي على قدر من السخرية، من خلال شخصيتيهما اللتين ابتكرهما تافاريس ابتكارًا. وإذا ما تأملنا الشخصية الرئيسة في رواية السيد تيست، وهي الرواية الوحيدة التي كتبها بول فاليري، نجد أن السيد تيست رجل لطيف على درجة مفرطة من الخجل وهو يحاول العيش في ظلال مبادئه الفكرية، وكذلك شخصية بلوم التي أبدعها هنري ميشو في مجموعته الشعرية النثرية المسمَّاة ريشة، سنجد أن هاتين الشخصيتين تشتركان في الكثير من النقاط مع شخصيتي السيد هنري وفاليري الأنيقتين في “الحي”. فهما شخصيتان مضطربتان، ومع ذلك تتحليان بالحكمة بشكل يثير الدهشة. فعلى سبيل المثال، نجد في إحدى القصائد النثرية لميشو، وعنوانها “رجل مغلوب على أمره” أن بلوم يستيقظ ليكتشف بأن جدران بيته اختفت، بيد أن ذلك الأمر لا يترك فيه سوى أثر لا يكاد يذكر إذْ ما يلبث أن يتابع نومه. وعندما يستيقظ مرة أخرى، يمر قطار فوقه وفوق زوجته، ولكنه يخلد للنوم على ذات المنوال الآنف الذكر. وعند استيقاظه مرة أخرى، يكتشف بأن أجزاءً من جسد زوجته لا تزال هناك وقد تركها القطار العابر، ولكن النعاس يغلب جفونه مرة أخرى. إن رباطة الجأش (الناعسة تلك) التي يواجه بها بلوم الكوارث التي تحصل في التناقض الصارخ بين الحلم وعوالم اليقظة تحيلنا إلى قصة “الحلم الأول للسيد كالفينو” في سلسلة الحي، إذ يتمكن السيد كالفينو أثناء سقوطه من بناء ارتفاعه ثلاثين طابقًا من ربط أنشوطة حذائه وربطة عنقه قبل لحظات من “ملامسة الأرض سليمًا معافى وهو بكامل أناقته”. أما في رواية السيد هنري فنجد أن هنري في قصة “النظرية” يقدِّم قفزات منطقية ربما تكون مصدر فخر للسيد تيست، وها أنذا أسوق لكم ذلك المقطع كاملًا من القصة المذكورة:
قال السيد هنري:
– اُخترع الهاتف ليتسنى للناس التحدث مع بعضهم من مسافات بعيدة. واخترع الهاتف ليبعد الناس عن بعضهم البعض، وشأنه في ذلك شأن الطائرات. فقد اخترعت الطائرات بحيث يستطيع الناس العيش بعيدين عن بعضهم. لو لم توجد الهواتف والطائرات لعاش الناس معًا.
وتابع قائلًا:
– هذه مجرد نظرية، ولكن فكروا بها، يا أصدقائي. ما يحتاج المرء القيام به هو أن يفكر في اللحظة المناسبة التي لا يتوقعها الناس. تلك هي الطريقة التي تفاجئونهم بها.
وقد يكون السطران الأخيران تعريفًا عمليا للنهج الذي يتبعه تافاريس القائم على إرباك القارئ في كل صفحة من صفحات كتاب “الحي”.
وأيًا تكن تأثيراته، فقد شيَّد غونزالو تافاريس لنفسه بنيانًا خياليًا لا يشبه أبدًا أي بنيان لأي كاتب برتغالي آخر. ومع ذلك تبقى حساسيته الأدبية متجذرة تجذرًا عميقًا في ثقافة بلده، ناهيك عن تجذرها خصوصًا في الحب والاحترام الَّلذين يكنُّهما للكتَّاب. إن أسماء الشعراء والكتاب، المعاصرين منهم والكلاسيكيين، غالبًا ما يتم تقديمها بشكل أسئلة في برامج المسابقات التلفزيونية في البرتغال. كما تهتم الصحف والمجلات بتقديم محفزات لشراء نسخها بشكل عملات معدنية قابلة للجمع تحفر عليها وجوه المؤلفين، أو تصدر طبعات بعدد نسخ محدود من آخر الأعمال الشعرية لشاعر من الشعراء. عندما أقمتُ في لشبونة كان أشهر برنامج مسابقات تلفزيونية هو برنامج تلفزيون الواقع المسمى (A Bella e o Mestre) حيث أن ثلاثة من أعضاء لجنة التحكيم البالغ عددهم أربعة هم من الكتَّاب. وقد أصبح شاعر القرن العشرين العظيم فرناندو بيسوا بعد وفاته أشبه ما يكون ببطل قومي في البرتغال، حيث استمرت طبعات جديدة من أعماله في الظهور عدا عن انتشار صوره على القمصان وأكواب القهوة وحمَّالات المفاتيح والدفاتر وفواصل الكتب وقطع البورسلان المزخرف، لا بلْ إن صوره تعدَّت كل تلك الأشياء حتى رسمها البعض على لوحات التنبيه بعدم الإزعاج التي تعلَّق على أبواب الغرف والتي احتوت على اقتباسات من شعره (ويوجد واحدة منها على باب غرفتي) يقول فيها: “إن شاء الله، سأنام، لأن عملًا أدبيًا جديدًا يشهد مخاضه الآن!”
ولكن بيسوا ليس الكاتب البرتغالي الوحيد الذي لا يزال الناس يحيون إرثه بكل حب واحترام. فعندما توفي الشاعر والفنان السريالي ماريو سيزاريني في شهر نوفمبر من عام 2006 خصصت كل الصحف الصادرة في العاصمة لشبونة صفحاتها الأولى وكامل الصفحات الست أو السبع التي تلتها على الأقل للحديث عن حياته وأعماله. ونالت الشاعرة فياما هاس بايس برناداو على الاهتمام نفسه عند وفاتها بعد ذلك ببضعة أشهر. وأينما وجهت ناظريك في لشبونة، تجد أن الشوارع والمنتزهات قد سميت بأسماء روائيين وشعراء وصحفيين؛ كما تنتصب شامخةً تماثيل أبرز الكتَّاب البرتغاليين في منتصف الساحات العامة وعلى جنبات الطرق الرئيسة. وحتى المدن الصغيرة لا تخلو من تماثيل لشعراء محليين أقل شهرة ومكانة.
هناك سبب لهذا التقليد المتوارث من الإعجاب بالأدب؛ سببٌ ذو جذور ثقافية وتاريخية متأصلة، حيث يقوم جزء كبير من الهوية الوطنية البرتغالية على المآثر غير المسبوقة التي أقدمت عليها تلك البلاد من خلال امتطاء صهوة الكشوفات الجغرافية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. فالاكتشافات العظيمة التي أدت لنشوء الإمبراطورية البرتغالية التئمت مع فجر انبثاق أوائل الأعمال الأدبية البرتغالية الحديثة، ولا يقتصر ذلك فحسب على أعمال لويس دي كامويس الذي كان هو ذاته مستكشفًا أيضًا، حيث احتفى عمله الأدبي الرئيس المتمثل بالقصيدة الملحمية اللوسياد باكتشافات فاسكو دي غاما، ولكننا نجد أثر ذلك أيضًا في المسرحيات التي تموج بالشك التي ألَّفها الكاتب المسرحي جيل فيسنتي. وفي حين تجري تلك المغامرات التي جابت أرجاء الكرة الأرضية في الماضي البعيد، فأنا أعتقد بأن البرتغاليين يعتبرون أن كتَّابهم يتابعون مسيرة المستكشفين وإرثهم، رغم أنه يأخذ الآن منحى آخر؛ فهم مكتشفون لا يشق لهم غبار للإمبراطوريات الداخلية لبني الإنسان.
فلا عجب إذن من احتضان البرتغاليين لأعمال غونزالو تافاريس، التي غالبًا ما تحتفي احتفاءً هزليًا رشيقًا بالحالات الذهنية والفكرية لكتَّاب مشهورين. ويعد كتاب المكتبة أول ما أينع من أعمال تافاريس الأدبية، إذ نشر في عام 2004، وهو تاريخ قريب من تاريخ ظهور أولى روايات سلسلة “الحي”. يضم كتاب المكتبة في صفحاته زهاء ثلاثمائة قصيدة نثرية قصيرة، تتناول كل قصيدة منها كاتبًا مختلفًا، من الكاتب الأرجنتيني أدولفو بيوي كاساريس إلى الأديب الصيني زانغ كيجيو. ويلجأ تافاريس في كتاب المكتبة لاستخدام أسلوب كتابي يشبه ذلك المستخدم في سلسلة كتاب الحي، ويتجلى ذلك من خلال خلق فسحة مكانية يمكن من خلاها لخيال الكاتب الذي تتحدث عنه القصيدة أن يصول ويجول. تشبه تلك القصائد النثرية البذور الصغيرة، وتشبه موضوعاتها الموضوعات التي تناولتها قصص سلسلة “الحي” الموجودة في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، في حين تُرِكت شخصيات أدبية أخرى مثل ميشيما وفرجينيا وولف (آن لنا أن نفرح لظهور شخصية أدبية نسائية أخيرًا!) وغوغول لتكون إضافات للأجزاء القادمة المتوقَّعة من سلسلة الحي.
ويبوح لنا كتاب المكتبة بمضامينه وكأنه نزهة في الشطآن المتنوعة للتأثير الذي يجمع بين أعمال تافاريس وجوهر مكتبته الشخصية – ولا نقصد المكتبة برفوفها وكتبها، بل تلك المكتبة القابعة داخل رأسه. وهذا هو السر، برأيي، الذي يربط تافاريس ارتباطًا لا تنفصم عراه مع القارئ، السر الذي يموج في العوالم الدائمة الاتساع داخل الحي. ففي كل واحد منا مكتبة داخلية؛ في كل واحد منا ذلك الصخب الداخلي للخيالات المختلفة للكتَّاب الذين نحبهم ونعجب بهم؛ في كل واحد منا تلك المكتبة التي تحتفظ في سراديبها بجبروت العوالم الخيالية لذلك الصنف من الكتاب كلما تقدم بنا العمر وتلاشت معه التفاصيل الدقيقة لكتبنا المفضلة. يبقى جبروت الخيال، إذن، ويتحول إلى حي شخصي بكل ما في الكلمة من معنى. عندما نزور حي تافاريس، بمبانيه وبيوته المبنية من الكتب، فإننا نزور أيضًا نسخة عن ذواتنا.
وقد ورد عن جوزيه ساراماغو، الذي صرَّح ذات مرة بكل خفة ودعابة بأنه يرغب بضرب تافاريس بدافع الغيرة منه، أنه قال، وإنْ بأسلوب أقل تهديدًا: “لقد اقتحم غونزالو تافاريس المشهد الأدبي البرتغالي مدججًا بخيال أصيل كل الأصالة، وقد تخطَّى به كل الحدود التقليدية للخيال. وأتوقع أنه سيفوز بجائزة نوبل للآداب خلال مدة ثلاثين عامًا، أو ربما قبل ذلك، وأنا على يقين من أن نبوءتي ستتحقق. الشيء الوحيد الذي يؤسفني هو أنني لن أكون هناك لأبارك له فوزه وأعانقه عناق المهنئين”.
هذا هو حال الدنيا إذًا، فما من أحد يعلم المخبوء في المستقبل. كل ما نعرفه الآن، للأسف، هو أن ساراماغو، الذي رحل عن عالمنا في عام 2010، لن تتاح له الفرصة لعناق تافاريس وتهنئته بالفوز بجائزة نوبل فيما لو فاز بها. وإنْ حصل وفاز تافاريس بالجائزة، فإن إنجازه المتمثل في النمو السكاني المطرد للحي الذي أنشأه في عمله الأدبي سيكون عاملًا مهمًا في منحه تذكرة سفر لاستلام جائزة نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم.
فيليب غراهام
أستاذ الكتابة الإبداعية ومحرر روائي في مجلة ناينث لِتَر
جامعة إلينوي، أوربانا-تشامبين، الولايات المتحدة الأمريكية
مؤلف كتاب أيها القمر: أقبل إلى الأرض: رسائل من لشبونة